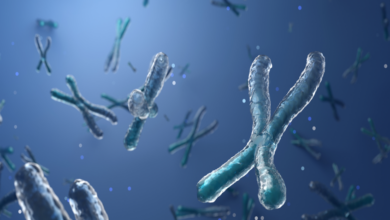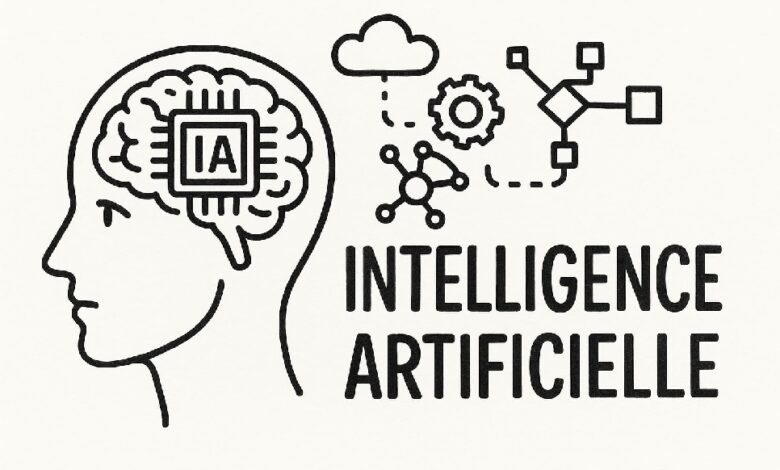
نهدف في هذا المقال إلى مساءلة الظهور المفاجئ والمدهش للذكاء الاصطناعي التوليدي، لا بوصفه مجرد تطور تقني عابر، بل كتحول معرفي وروحي في آنٍ معًا. فالظاهر أن هذه الثورة لا تقتصر على تسهيل المهام أو تسريع الإنتاج فحسب، بل إنها تفتح أمام الإنسان أبوابًا غير مسبوقة لما يمكن أن نسميه ” تحقيق معجزة الحيوات المتعددة”. كيف ذلك؟ لنتأمل الأمر من زاوية الفعل المعرفي: في السابق، كان إعداد تقرير بحثي أو تأليف مقال علمي يتطلب من الباحث أسابيع، وربما شهورًا من القراءة والتحليل والكتابة والمراجعة. وكان الزمن يُستهلك كما تُستهلك طاقة الجسد والفكر، حتى صار الإنجاز المعرفي مرادفًا للتعب والبذل الطويل.

خبير الذكاء الاصطناعي و الرقمنة، كاتب، استاذ باحث بالمعهد العالي للاعلام و الاتصال، الرباط، المغرب
أما اليوم، في ظل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصبح بإمكان الباحث أو المبدع أن يُنجز في دقائق ما كان يحتاج إلى شهور، بل وبدقة أعلى، وتماسك منطقي قد يفوق أحيانًا قدرات الإنسان المشتت بين مصادر لا حصر لها. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي قد حلّ محلّ العقل، بل بالأحرى أنه قد صار معينًا له، وامتدادًا لإرادته، ومسرّعًا لتجلياته. و هنا لا مانع إذا من القول ان الإنسان الذي يتقن استخدام هذه الأدوات التوليدية يصبح قادرًا على أن يعيش، معرفيًا، حيوات متعددة في زمن وجيز، كأنما يلخّص اعمارا معرفية كاملة في دورة واحدة من العمل المستغرق والمركّز.
وهنا تلوح أمامنا فكرة “الحيوات المتعددة”، لا باعتبارها ضربًا من الخيال العلمي، ولكن كطي للزمان و كواقع فعلي يتجلّى في ممارساتنا اليومية مع هذه الأدوات الذكية. فالإنسان الذي كان يحتاج إلى عشرين سنة ليُتقن مهنة معينة، يمكنه اليوم، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أن يُنجز محتوى بجودة مهنية مكثفة خلال ساعات معدودة. ومن كان يحتاج إلى فريق من المحررين والمترجمين والمصممين لينتج محتوى متكاملاً، صار بإمكانه بمفرده أن يُدير سلسلة إنتاج معرفي رقمية، بفضل أدوات قادرة على التحرير والتلخيص والترجمة والتصميم في آن واحد.
لكن، وهنا مكمن المفارقة، هذا التحول لا ينبغي أن يُقرأ قراءة تقنية محضة. إن ما يحدث هو تغير في بنية الزمن المعرفي، بل في فلسفة العمل الإنساني ذاته. فبينما كان الزمن سابقًا يُستهلك في المقدمات، فانه الآن يُستثمر في النتائج. وبينما كان الجهد مبعثرًا بين خطوات إنتاجية مرهقة، صار اليوم مركزًا في الاختيار والتوجيه والتقييم. وهذا، في جوهره، ليس تسهيلًا سطحيًا، بل ترقية لمقام الإنسان في علاقته بالمعرفة.
فهل نحن أمام ولادة نمط جديد من الكينونة الإنسانية؟
يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر أثره على اختصار الزمن وتقليص الجهد، بل يتعدّى ذلك إلى إعادة تشكيل علاقة الإنسان بالمعرفة، وبذاته أيضًا. لقد تعوّد الإنسان، عبر قرون، أن يقترن الفعل المعرفي بالمشقة والمكابدة وطول المران، وكان ذلك في ذاته مدخلاً إلى تهذيب النفس وتعميق الشعور بالمسؤولية تجاه ما يُنتجه من فكر أو خطاب أو أثر. أما الآن، فإنّ هذا النسق يوشك أن ينقلب، أو لنقل يتحول، حيث لم تعد القيمة تقاس بالزمن المبذول، بل بالذكاء المصرف في توجيه الأداة. وهذا يثير تساؤلاً عميقًا: هل تغيّر معنى الإبداع؟ وهل أصبح المفكر أو الكاتب مجرد مشرف على ما تنتجه الآلة؟
الأهم من ذلك، أن هذا التحول لم يأتِ كاكراه خارجي، بل استُقبل بترحاب منقطع النظير، خاصة من أولئك الذين طالما عانوا من بطء الأدوات القديمة. فها هم الان وجدوا في الذكاء الاصطناعي حليفًا صامتًا لا يشتكي ولا يتعب، بل يتقن وينجز ويتطوّر ذاتيًا مع الزمن. وبهذا، صار العمل المعرفي أشبه ما يكون بشراكة غير متكافئة بين عقل بشري يضع البوصلة، وعقل آلي يفتح الطرق ويمهّدها بأسرع مما كان يخطر بالبال.
ولا غرو أن نجد كثيرين ممن خاضوا هذه التجربة، يشعرون كأنما قد مُنحوا فرصة ثانية للولادة العلمية أو الأدبية. فمن كان يخاف من الخوض في مشاريع بحثية بسبب ضيق الوقت أو قلة الموارد، أصبح اليوم يشعر أن لديه جناحان ليحلق بحرية. ومن كان يهاب التأليف أو التحليل أو الترجمة، أصبح يجد لذة في تشكيل النصوص وتعديلها وتوجيهها. والأعجب من ذلك، أن بعضهم استطاع أن يبدع أكثر مما ظنّ، حين اكتشف أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصيه، بل يُعينه على أن يكون نسخة أكثر إشراقًاو اكتمالا من نفسه.
لكن، في خضم هذه الحيوات المتعددة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، لا بد من التحذير من وهم السيطرة الكاملة. فالأداة، مهما بلغت من الدقة، لا تستطيع أن تعوض الروح. والروح هنا ليست فقط الشعور أو الذوق، بل هي القصد، والمعنى، والمسؤولية. ومن ثم، فإن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُفهم بوصفه بديلاً عن الإنسان، بل هو مكمل له، و هو مرآة تعكس عمق رؤيته أو ضحالتها. وبهذا، يغدو استخدام الذكاء الاصطناعي معيارًا جديدًا في تقييم قدرات الإنسان، لا من حيث ما ينجزه فقط، بل من حيث كيفية استثمار ما لديه من أدوات في توليد المعنى.
فمن أحسن استخدام هذه التكنولوجيا، فإنما يزيد من عمقه وتنوعه المعرفي، وكأنه يعيش، بحق، حياة معرفية ثانية، وربما ثالثة و رابعة و عاشرة، في الزمن نفسه. وهذا هو المقصود بالحيوات المتعددة: انه ليس معنى التكرار، بل هو طي الزمان و توسيع التجارب وتعميق الأثر الذي تحدثه.
دعونا نُبسّط الصورة حتى لا يستولي التهويل على عقولنا، ولا يستدرجنا الإعجاب السطحي بما يبدو “معجزة الحيوات المتعددة للذكاء!الاصطناعي” إلى إغفال المقاصد الأعمق من هذا التحوّل. فالذكاء الاصطناعي التوليدي، في جوهره، ليس عصا سحرية تصنع المعجزات، ولا هو نبيّ العصر الجديد الذي يُملي علينا ما نفعل، بل هو مجرد أداة ومصيرها الأخلاقي والوظيفي متعلق بكيفية استخدامها. و هنا ينبغي أن نُميز بين الاستعمال الآلي المحض، الذي يُنتج كمًّا متراكمًا من النصوص، والاستعمال الواعي المؤصّل، الذي يجعل من الذكاء الاصطناعي شريكًا في عملية التفكير وليس مجرد مكرر آلي للمعاني.
والملاحظ أن كثيرًا من المشتغلين بالمحتوى قد وقعوا في أسر الانبهار، فصار همّهم الأول هو السرعة والكثرة، لا العمق والجودة. فبات المحتوى يُقاس بعدد الكلمات، لا بدرجة إشعاعه المعرفي، وبعدد المشاهدات، لا بنسبة التأثير والتحوّل. وهنا، يبدو أن الذكاء الاصطناعي، بدل أن يُحرر الإنسان من سطحية السوق، قد استُخدم كوسيلة لتعميق منطق السوق نفسه: الربح، الاستهلاك، التسابق و التهافت نحو التفاعل. وهذا يُنذر بأننا، دون وعي، قد نُلبس أدوات التحرر أثواب العبودية، ونستبدل ببطء القيد القديم بقيد جديد، وإن كان ناعما وذكيًا.
ولا مناص، إذا، من العودة إلى سؤال المقصد. لماذا نكتب؟ و لماذا ننتج؟ ولماذا نستعين بهذه التقنيات؟ فإن كانت الغاية هي مجرد تسريع عجلة الإنتاج، فإننا نكون قد أضعنا البوصلة الأخلاقية والفكرية التي تُعطي للمحتوى قيمته. أما إن كانت النية هي تعزيز جودة الفكر، وتوسيع آفاق الإنسان، وتخفيف العبء التقني لكي يتفرغ للعميق من القضايا، فهنا يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إلى “رفيق في درب المعرفة”، اذ يسهم في بناء إنسان أكثر وعيًا وحرية ومسؤولية.
الظاهر، إذا، أن الذكاء الاصطناعي يعيد توزيع الأدوار بين الإنسان والآلة: فلم تعد الآلات تقوم بما لا يستطيع الإنسان فعله، بل أصبحت تقوم بما لا يجب أن يُرهق الإنسان بفعله، حتى يتفرغ لما يليق بكرامته العقلية والروحية. وهذا التحول، إن أُدير بعناية، يمكن أن يُفضي إلى نهضة فكرية غير مسبوقة. لكن بشرط: أن يُضبط بالأخلاق، ويُوجه بالبصيرة، ويُوظّف في خدمة الإنسان، لا في استلابه.
و نود ان نضيف أننا لا نرفض التقنية، ولا نبالغ في تمجيدها، بل نؤمن بأنها، ككل نعمة، تحتاج إلى عقل راشد يتلقّاها، وقلب يقظ يحركها، وسؤال دائم هو التالي : “هل ما ننتجه بواسطتها، يزيد من إنسانيتنا أم ينقص منها؟”
و ختامًا، نستطيع أن نقول، دون تهويل أو إنكار، ان الذكاء الاصطناعي التوليدي قد فتح أمام الإنسانية بابًا لم يكن مُتصوّرًا قبل عقد من الزمان. انها بالاحرى بوابة تفضي إلى عالم تتداخل فيه الأبعاد: الزمان يُختصر، والمكان يُلغى، والمهام تُضاعف، والعقول تتمدد و تتضاعف. غير أن هذا الباب، وإن بدا مفتوحًا للجميع، إلا أنه لا يؤدي إلى نفس الطريق لكل الناس، بل إلى طرق تختلف باختلاف نية المستخدم، واستعداده الأخلاقي، ومقامه المعرفي.
فمنهم من اتخذ من الذكاء الاصطناعي وسيلةً للهروب من الجهد، فركن إلى الراحة والاعتمادية المطلقة، فاكتفى بإعادة تدوير المعرفة دون إضافة أو فكر. ومنهم من رآه “حيلة” للوصول السريع إلى الغايات دون عناء، فحوّل النصوص إلى سلع، والكتابة إلى عملية استنساخ، والتفكير إلى مجرد ترتيب آلي لعبارات محفوظة. أما الفريق الثالث، وهم القلة، فقد أبصروا في هذه الأداة امتدادًا لقدرتهم على التعبير، وفرصة لتعميق اشتغالهم الفكري، واستثمارًا ذكيًا في وقتهم وحياتهم، دون أن يتخلوا عن أصالة الرؤية أو حرمة المعنى.
ولعله من البديهي، إذا، أن نسأل أنفسنا: ما موقع الإنسان في هذا المشهد الجديد؟ هل هو مجرد مبرمج لما تُنتجه الآلة، أم هو مرشدها، وضميرها الأخلاقي، وبوصلتها الوجودية؟ فالذكاء الاصطناعي، في جوهره، لا يحمل نية ولا غاية، بل هو لوحة بيضاء، ينقش عليها الإنسان ما يشاء. وهنا تتجلى الخطورة والفرصة معًا: فإن كان الإنسان مهتديًا بنور الحكمة، ومُستنيرًا بأخلاق الفهم، فإنه سيجعل من هذه الأداة مصباحًا يضيء له الطريق نحو مزيد من الإبداع والتميّز. أما إذا كان غارقًا في الاستهلاك والسطحية، فإنه سيحفر بها قبرًا لقيمه، ويجعل منها سوطًا يُجلد به ضمير الإبداع.
والمأمول، في نهاية المطاف، أن نتجاوز النقاش التقني البارد إلى خطاب معرفي إنساني، نُعيد فيه تحديد العلاقة بين “الأداة” و”الغاية”، وبين “السرعة” و”العمق”، وبين “التقنية” و”المعنى”. فليس المهم أن نُنجز كثيرًا، بل أن يكون لما ننجزه أثرٌ يبقى، وأن نُنتج نصوصًا لا تُشبه بعضها، بل تشبهنا، اي تشهد لتجربتنا، وتُجسد وعينا، وتخاطب الإنسان فينا.
إن الذكاء الاصطناعي، إذا ما وُضع في موضعه الصحيح، يمكنه أن يفتح للإنسان بابًا إلى “الحياة الثانية” التي طالما حلم بها الفلاسفة والمفكرون: و هي ليست بحياة جسدية، بل حياة فكرية تتسع لقرون من المعنى داخل لحظة من الوعي. لكن هذا مقترن بشرط واحد: أن نُبقي على الإنسان في مركز الدائرة، لا تابعًا، ولا خادمًا، بل سيّدًا أخلاقيًا مسيطرا مهيمنا على هذه الادوات.
فهل نمتلك هذا الوعي؟