مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23:من منطق الإصلاح إلى منطق الضبط..قراءة نقدية دستورية
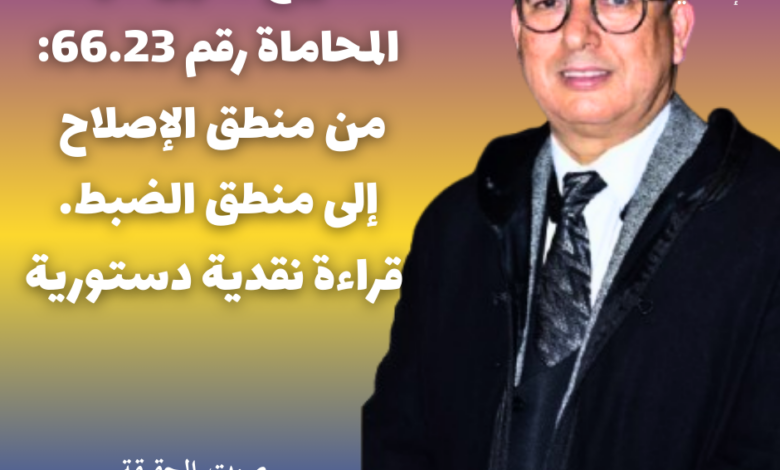
بقلم: ذ. زهير أصدور – محام بهيئة الرباط
مقدمة:
تُعدّ مهنة المحاماة إحدى الدعائم البنيوية لمنظومة العدالة الحديثة، لا باعتبارها مجرد نشاط مهني منظم يخضع لقواعد السوق أو لمنطق التنظيم الإداري، بل بوصفها وظيفة دستورية أصيلة تضطلع بدور محوري في ضمان التوازن داخل الخصومة القضائية، وتجسيد الحق في الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم بدونها المحاكمة العادلة.
وقد كرس دستور المملكة هذا الحق ضمن منظومة متكاملة من الضمانات، حيث لا يُنظر إلى الدفاع كامتياز إجرائي، بل كشرط جوهري لمشروعية القضاء ذاته، وعنصر لا ينفصل عن حماية الحقوق والحريات وصيانة الأمن القانوني. وانطلاقًا من هذه المكانة، فإن تنظيم مهنة المحاماة يكتسي طابعًا خاصًا يميّزه عن باقي المهن الحرة، إذ لا يخضع فقط لمنطق التقنين التقني أو الاعتبارات التدبيرية، وإنما يتصل اتصالًا مباشرًا بالبنية الدستورية للدولة وبمفهوم دولة الحق والقانون.
ولذلك، فإن أي تدخل تشريعي يروم إعادة تنظيم هذه المهنة لا يمكن تقييمه من زاوية النجاعة الإدارية أو تحديث آليات الممارسة فحسب، بل يجب أن يُخضع لمعيار أسمى، قوامه مدى احترام استقلال المهنة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، وصيانة حصانة الدفاع باعتبارها ضمانة للمجتمع قبل أن تكون امتيازًا للمحامي، وضمان حق المهنة في التنظيم الذاتي الديمقراطي باعتباره أحد تجليات استقلالها المؤسسي.وفي هذا الإطار، أحالت الحكومة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مرفقًا بمذكرة تقديمية تروم – وفق التصور الرسمي – تبرير مراجعة شاملة للقانون رقم 28.08 الصادر سنة 2008، بدعوى تقييم حصيلته بعد مرور سبعة عشر سنة على دخوله حيز التنفيذ، واستحضار التحولات التي عرفتها منظومة العدالة والتشريعات الوطنية والدولية.
غير أن القراءة المتأنية لمذكرة التقديم، سواء من حيث منطلقاتها أو من حيث مضامينها، تثير تساؤلات جوهرية تتجاوز الطابع التقني للإصلاح، لتلامس الأسس الفلسفية والدستورية التي يقوم عليها تنظيم المهنة.فالسؤال المركزي الذي يفرض نفسه لا يتعلق فقط بجدوى التعديل أو التطوير، بل بحقيقة الحاجة الموضوعية إلى نسخ قانون حديث نسبيًا وإحلال نص جديد محله، دون تقديم تشخيص دقيق ومعلّل للاختلالات البنيوية التي تعذّر معالجتها في إطار القانون القائم.
كما يثور التساؤل حول ما إذا كان المشروع المقترح يشكّل بالفعل تطورًا نوعيًا يعزز استقلال المهنة ويقوي دورها الدستوري داخل منظومة العدالة، أم أنه ينطوي، في عمقه، على إعادة ترتيب للعلاقة بين الدولة والمحاماة على نحو قد يمس بجوهر استقلالها، ويفتح المجال لتحويل منطق الإصلاح إلى منطق الضبط والتحكم.
وعليه، فإن مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 لا يمكن أن تظل حبيسة تعداد المستجدات أو مقارنة الصياغات القانونية، بل تقتضي مقاربة نقدية دستورية تتساءل عن الاتجاه العام للنص، وعن مدى انسجامه مع فلسفة الحقوق والحريات، ومع الدور التاريخي والوظيفي للمحاماة كسلطة مهنية مستقلة تسهم في تحقيق العدالة، لا كجهاز ملحق بها أو خاضع لإشرافها الإداري.
أولًا: هل كانت مهنة المحاماة في حاجة فعلية إلى قانون جديد؟ تؤسس مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 66.23 منطلقها الإصلاحي أساسًا على عنصر الزمن التشريعي، معتبرة أن مرور سبعة عشر سنة على صدور القانون رقم 28.08 يشكل، في حد ذاته، مبررًا كافيًا لإجراء مراجعة شاملة لهذا النص.
غير أن هذا الطرح يثير إشكالًا منهجيًا جوهريًا، يتمثل في الخلط بين التقادم الزمني للنص القانوني وبين تقادمه الوظيفي. فالتشريع، في منطق الدولة الدستورية، لا يفقد صلاحيته لمجرد مرور الزمن، وإنما يُقاس بمدى قدرته على الاستجابة لحاجيات الممارسة، واستيعاب التحولات الواقعية، وتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.ومن ثم، فإن عنصر الزمن، وإن كان قد يشكل مناسبة لإجراء التقييم، لا يمكن أن يرتقي، بمفرده، إلى مرتبة المعيار الحاسم الذي يبرر نسخ قانون قائم وإحلال نص جديد محله، ما لم يُدعَّم بتشخيص دقيق ومعلل للاختلالات البنيوية التي أثبتت التجربة العملية عجز النص القائم عن معالجتها. فالتشريع الرشيد لا يقوم على منطق القطيعة الدورية، بل على مبدأ الاستمرارية والتراكم، حيث يُفترض في كل تدخل تشريعي جديد أن يبني على المكتسبات القائمة، ويعالج الثغرات المحددة دون المساس بالبنية العامة للنص إلا عند الضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، يظل القانون رقم 28.08، من زاوية المنظور التشريعي المقارن، قانونًا حديث العهد نسبيًا، لا سيما إذا ما قورن بعدد من القوانين المنظمة للمهن القضائية أو الحرة، والتي ما تزال تؤطرها نصوص أقدم بكثير، دون أن يشكل عامل الزمن في حد ذاته دافعًا لنسخها كليًا. بل إن التجارب التشريعية المقارنة تميل، في الغالب، إلى اعتماد آلية التعديلات المرحلية والمتدرجة، حفاظًا على الاستقرار القانوني والأمن التشريعي، وتفادي الآثار السلبية التي قد تترتب عن التغييرات الجذرية المفاجئة.
وإذا ما انتقلنا من منطق التبرير الزمني إلى واقع الممارسة المهنية، فإن أغلب الإشكالات التي أفرزها تنزيل القانون رقم 28.08 خلال السنوات الماضية لا تبدو، في جوهرها، ناتجة عن قصور تشريعي بنيوي، بقدر ما ترتبط بعوامل خارج النص القانوني ذاته. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بضعف تفعيل بعض المقتضيات القائمة، سواء على مستوى التكوين أو التأديب أو التنظيم المهني، وباختلالات هيكلية تعاني منها منظومة العدالة بصفة عامة، ولا يمكن تحميل مسؤوليتها حصريًا للنص المنظم لمهنة المحاماة.
كما لا يمكن إغفال الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تمس المهن الحرة بوجه عام، في سياق تحولات سوق الشغل وتنامي الضغوط المعيشية، وهي إكراهات لا يعالجها تغيير النص القانوني في حد ذاته، ما لم تُواكَب بسياسات عمومية شمولية.وعليه، فإن الانتقال من منطق التعديل الجزئي والتجويد التشريعي إلى منطق النسخ الكلي وإعادة التأسيس يظل خيارًا تشريعيًا بالغ الكلفة، ليس فقط من حيث الجهد التشريعي والمؤسساتي، بل أيضًا من حيث ما قد يترتب عنه من مساس بالاستقرار القانوني والتنظيمي للمهنة.
وهو خيار لا يبدو أن مذكرة التقديم قد أسست له على مبررات موضوعية كافية، سواء من خلال تقييم محين وموثق لأوجه القصور في القانون القائم، أو عبر إبراز استحالة معالجتها بوسائل تشريعية أقل حدّة، الأمر الذي يفتح المجال للتساؤل حول الخلفيات الحقيقية لهذا التحول الجذري في تنظيم مهنة ذات حساسية دستورية خاصة.
ثانيًا: من تأهيل المهنة إلى التحكم في الولوج إليها .تقدّم الحكومة، من خلال مشروع القانون رقم 66.23، منظومة جديدة للولوج إلى مهنة المحاماة ترتكز على اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإرساء مسار تكويني متعدد المراحل يشمل التكوين الأساسي، والتمرين الممتد، ثم امتحان الكفاءة لممارسة المهنة. ويُسوَّق هذا التحول باعتباره استجابة لحاجة موضوعية إلى الرفع من جودة الأداء المهني، واستقطاب “أجود الكفاءات”، وضمان تكوين محامين قادرين على مواكبة تعقيدات العمل القضائي وتطور التشريعات الوطنية والدولية.
غير أن هذا الخطاب، على الرغم من وجاهته الظاهرية، يخفي في عمقه تحولًا جوهريًا في فلسفة الولوج إلى المهنة، يستدعي قراءة نقدية تتجاوز مستوى النوايا المعلنة إلى تفكيك الآثار البنيوية المتوقعة.فمن حيث المبدأ، كان الولوج إلى مهنة المحاماة، في إطار التشريع السابق، مؤسسًا على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق العلمي، باعتبارهما تجسيدين عمليين لمقتضيات دستورية صريحة، وعلى رأسها المساواة أمام القانون، والحق في الولوج إلى الوظائف والمهام على أساس الكفاءة. غير أن المنظومة المقترحة تنقل الولوج إلى المهنة من منطق الاستحقاق المفتوح إلى منطق الضبط والتحكم، حيث يصبح العدد عنصرًا حاسمًا في تحديد من له الحق في الانتماء إلى المهنة، دون أن تُواكَب هذه النقلة بضمانات تشريعية كافية تكفل الشفافية والاستقلالية والحياد في تدبير مساطر الانتقاء والتكوين.
ويزداد هذا التخوف حدة بالنظر إلى تضخيم الدور المسند إلى معهد التكوين، سواء في مرحلة الولوج أو في المراحل اللاحقة للمسار المهني، في غياب تحديد دقيق لطبيعته القانونية ولمدى استقلاله الوظيفي والمؤسساتي عن السلطة الحكومية الوصية. فالتكوين المهني للمحامين، بحكم ارتباطه المباشر بالحق في الدفاع، يفترض أن يظل مجالًا محصنًا من أي تدخل إداري أو توجيه غير مهني، وأن يُدار في إطار شراكة حقيقية مع الهيئات المهنية المنتخبة، لا أن يتحول إلى أداة مركزية لإعادة تشكيل المهنة وفق اختيارات لا تخضع للنقاش الديمقراطي داخل الجسم المهني.
كما أن تمديد فترة ما قبل الممارسة الفعلية للمهنة، عبر الجمع بين التكوين الأساسي والتمرين الطويل، يثير تساؤلات جدية حول مدى تناسب هذا الإجراء مع مبدأ المعقولية، وحول آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المترشحين، خاصة المنحدرين من أوساط اجتماعية متوسطة أو هشة.
فإطالة أمد الولوج دون ضمانات كافية للتعويض أو للإدماج المهني الفعلي قد يحول مسار المحاماة إلى مسار نخبوي مغلق، لا يلجه إلا من تتوفر لهم شروط مادية واجتماعية معينة، وهو ما يتعارض مع الدور التاريخي للمهنة كفضاء للترقي الاجتماعي ولإنتاج نخب قانونية مستقلة ومتنوعة.
ويُضاف إلى ذلك غياب نصوص تشريعية صريحة تحول دون توظيف نظام المباراة كآلية انتقاء غير معلنة، قد تُفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من محتواه، سواء من خلال التحكم في عدد المناصب المفتوحة، أو في معايير الانتقاء، أو في تركيبة لجان المباراة. فالمباراة، في غياب ضمانات دستورية وتشريعية واضحة، قد تتحول من أداة لضمان الجودة إلى وسيلة للضبط العددي والاجتماعي، وهو ما يطرح إشكالًا حقيقيًا على مستوى شرعية هذا الاختيار التشريعي.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري الذي يتجاوز حدود هذا المحور: هل الهدف الحقيقي من هذه المنظومة هو تأهيل المحامي والارتقاء بالمهنة، أم تقليص عدد المنتسبين إليها تحت ذريعة الجودة؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي لمهنة الدفاع دون مساءلة شروط اشتغال منظومة العدالة برمتها، بما في ذلك ظروف العمل القضائي، والخصاص البنيوي في الموارد البشرية، وضعف الإمكانات اللوجستيكية، وهي عوامل لا يمكن معالجتها عبر تضييق الولوج إلى المهنة، بل عبر إصلاح شامل ومتكامل للعدالة؟وعليه، فإن مقاربة الولوج إلى مهنة المحاماة، كما وردت في مشروع القانون رقم 66.23، تطرح إشكالًا مزدوجًا: فهي، من جهة، ترفع شعار الجودة والتأهيل، ومن جهة أخرى، تؤسس لمنطق تحكمي قد يُفضي إلى تقويض المبادئ الدستورية المؤطرة للولوج إلى المهن القضائية، وإلى إعادة تشكيل الجسم المهني على أسس لا تخلو من مخاطر على استقلال الدفاع ودوره داخل منظومة العدالة.
ثالثًا: المساس باستقلال المهنة تحت غطاء التنظيم. لعل أخطر ما ينطوي عليه مشروع القانون رقم 66.23 لا يتمثل في المقتضيات التقنية أو الإجرائية التي جاء بها، بقدر ما يكمن في التحول البنيوي الذي يُحدثه على مستوى فلسفة العلاقة بين مهنة المحاماة والسلطة التنفيذية. فبعيدًا عن خطاب التحديث والتنظيم الذي يرافق تقديم المشروع، يتضح من خلال القراءة المتأنية لمضامينه أنه يعيد رسم حدود هذه العلاقة على نحو يُفضي إلى تقليص مجال الاستقلال الذاتي للمهنة، وإلى إعادة إدماجها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن دائرة الإشراف الإداري.
ويتجلى هذا التحول أساسًا في توسيع صلاحيات وزير العدل، سواء من حيث الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية أو من حيث التدخل في بعض مفاصل التنظيم المهني. فرغم أن تنظيم مزاولة المحامين الأجانب للمهنة قد يبدو، في ظاهره، مسألة تقنية مرتبطة بجذب الاستثمار وضمان الأمن القانوني للمعاملات، فإن إسناد سلطة الترخيص الاستثنائي لوزير العدل، خارج منطق التنظيم الذاتي الذي يفترض أن تضطلع به الهيئات المهنية، يطرح إشكالًا مبدئيًا يتعلق بحدود تدخل السلطة التنفيذية في شؤون مهنة قضائية مستقلة بطبيعتها.
إذ إن منطق الترخيص، خاصة عندما يكون استثنائيًا ومرتبطًا بتقدير إداري، يتعارض مع مبدأ المساواة ومع متطلبات الشفافية، ويُخضع ممارسة مهنية ذات بعد دستوري لاعتبارات قد تكون ظرفية أو غير قابلة للرقابة المهنية.كما يتعزز هذا المنحى من خلال الإشراف غير المباشر على ولوج المهنة، سواء عبر التحكم في منظومة المباراة أو عبر الدور المحوري الممنوح لمؤسسات التكوين، دون أن يقابل ذلك إقرار ضمانات تشريعية صريحة تكفل استقلال هذه المساطر عن السلطة الحكومية. فولوج المهنة، باعتباره مدخلًا لتجديد الجسم المهني، يُعد من أكثر المراحل حساسية، وأي تدخل غير مهني في تدبيره من شأنه أن يؤثر في طبيعة المحاماة نفسها، وفي قدرتها على أداء وظيفتها النقدية والحقوقية داخل منظومة العدالة.
إلى جانب ذلك، يتضح تدخل السلطة التنفيذية أيضًا من خلال إعادة هندسة التنظيم المؤسساتي للمهنة، سواء عبر إحداث مجلس مجلس وطني بصيغة تجعل منه مخاطبًا مركزيًا وحيدًا، أو عبر إعادة توزيع الاختصاصات على نحو قد يُضعف دور الهيئات المنتخبة.
ورغم أن توحيد التمثيلية قد يُقدَّم باعتباره آلية لتقوية التنسيق والنجاعة، فإن الخطر يكمن في تحويل هذا الإطار المؤسساتي إلى قناة لتسهيل الضبط المركزي للمهنة، بدل أن يكون فضاءً لتكريس استقلالها وتعددية تمثيلها.ويُفضي مجموع هذه المقتضيات إلى إعادة إنتاج منطق الوصاية، في تعارض صريح مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهن القضائية، وهو مبدأ مستقر في الأنظمة الدستورية المقارنة، ويُعد شرطًا لازمًا لضمان استقلال الدفاع.
فالمحاماة، بوصفها مهنة تشتغل في تماس مباشر مع السلطة القضائية ومع الحقوق والحريات، لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الدستورية على الوجه المطلوب إذا كانت خاضعة لإشراف أو توجيه السلطة التنفيذية، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تنظيمية ملتوية.
إن مهنة المحاماة لا تستمد مشروعيتها من الدولة ولا من تفويض إداري، بل من وظيفتها الدستورية المتمثلة في حماية الحق في الدفاع والمساهمة في تحقيق العدالة. وكل إخضاع لها لمنطق الترخيص أو الاستثناء أو التقدير الإداري يُفرغها من مضمونها كسلطة مهنية مستقلة وموازية داخل منظومة العدالة، ويحوّلها تدريجيًا من فاعل حقوقي ناقد إلى مجرد مكون تقني خاضع لمنطق الضبط.
ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي في تنظيم مهنة المحاماة لا يكمن في إحكام الرقابة عليها، بل في تحصين استقلالها باعتباره ضمانة للمجتمع ككل، لا امتيازًا لفئة مهنية بعينها.
رابعًا: حصانة الدفاع… من الضمان إلى القيد.
يتضمن مشروع القانون رقم 66.23 جملة من المقتضيات التي تُقدَّم على أنها ترمي إلى تعزيز حصانة الدفاع، من بينها التنصيص على إلزامية إشعار نقيب الهيئة في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، خاصة عندما يكون الاعتقال مرتبطًا بممارسة المهنة. ولا شك أن هذه المقتضيات، من حيث المبدأ، تمثل اعترافًا تشريعيًا بخصوصية وضع المحامي وبحساسية الدور الذي يضطلع به داخل منظومة العدالة، وتنسجم جزئيًا مع المعايير الدولية التي توصي بضمان حماية خاصة للمدافعين عن الحقوق.
غير أن هذه المقتضيات الإيجابية الشكلية لا يمكن فصلها عن الوجه الآخر للمشروع، الذي يتجلى في إدراج قيود جديدة تمس جوهر حصانة الدفاع، ليس من زاوية المتابعة الفردية للمحامي فحسب، بل من زاوية التعبير الجماعي للمهنة عن مواقفها إزاء القضايا التي تمس استقلال القضاء أو شروط ممارسة الدفاع.
ويتجسد هذا التضييق، على وجه الخصوص، في منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وكذا في فرض قيود رمزية وسلوكية يُفهم منها السعي إلى تحييد أي بعد احتجاجي أو تعبوي للمهنة داخل فضاء يُعد، تاريخيًا، مجالًا لتجسيد رمزية الدفاع.
إن حصانة الدفاع، في معناها الدستوري الواسع، لا تختزل في توفير ضمانات إجرائية تحمي المحامي من الاعتقال التعسفي أو المتابعة غير المبررة، وإنما تمتد لتشمل حماية حرية التعبير المهني والجماعي للمحامين، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحق في الدفاع نفسه.
فالمحامي لا يدافع فقط داخل قاعة الجلسات عن مصالح موكله الفردية، بل يضطلع، بحكم موقعه، بدور أوسع يتمثل في الدفاع عن القيم المؤطرة للعدالة، وعن استقلال القضاء، وعن شروط المحاكمة العادلة. وأي مساس بحقه في التعبير عن مواقف مهنية جماعية، كلما تعرّضت هذه القيم للتهديد، يُعد مساسًا غير مباشر بالحق في الدفاع كحق مجتمعي عام.
ومن هذا المنظور، فإن تحويل فضاء المحكمة إلى مجال منزوع الرمزية النضالية، يُفرغ هذا الفضاء من أحد أبعاده التاريخية والحقوقية، ويعيد تعريف دور المحامي بوصفه فاعلًا تقنيًا محايدًا، لا يحق له سوى تنفيذ مهام إجرائية محددة سلفًا. والحال أن التجارب الدستورية المقارنة تُبرز أن قوة مهنة المحاماة واستقلالها لا تقاسان فقط بمدى احترام شكلياتها، بل أيضًا بقدرتها على التعبير الجماعي المنظم عن مواقفها، في إطار احترام النظام العام وسير العدالة، دون أن يُفرض عليها صمت مؤسساتي باسم الانضباط أو الهيبة.
كما أن القيود الرمزية والسلوكية المفروضة على المحامين، حين تُقرأ خارج سياقها التأديبي الضيق، تثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية منها، خاصة إذا لم تُقرن بمعايير دقيقة تميز بين ما يُعد إخلالًا بواجبات المهنة، وما يندرج ضمن حرية التعبير المهني المشروعة.
فالتوسع في مفهوم النظام داخل المحاكم، دون ضبط تشريعي صارم، قد يفتح المجال لتأويلات واسعة تُستخدم لتقييد أي شكل من أشكال الاحتجاج المهني السلمي، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات.
وعليه، فإن مشروع القانون، وهو يوازن بين تعزيز بعض ضمانات الحماية الفردية للمحامي وبين تقييد التعبير الجماعي للمهنة، ينتقل بحصانة الدفاع من كونها ضمانة إيجابية تروم تمكين المحامي من أداء وظيفته الحقوقية كاملة، إلى أداة ضبط تُفرغ هذه الحصانة من بعدها النضالي والرمزي. وهو انتقال يطرح إشكالًا جوهريًا حول طبيعة الدور الذي يُراد لمهنة المحاماة أن تضطلع به داخل منظومة العدالة: هل هو دور فاعل حقوقي مستقل يساهم في حماية العدالة، أم دور تقني منضبط يُطلب منه الامتثال دون مساءلة؟
خاتمة: إن تقييم أي قانون جديد منظم لمهنة المحاماة لا يمكن أن ينصرف إلى قياس درجة إحكامه للتقنيات التنظيمية أو اتساع دائرة الضبط التي يفرضها على الممارسة المهنية، بل ينبغي أن يُقاس، أساسًا، بمدى الإضافة النوعية التي يقدمها مقارنة بالنص السابق، وبقدرته على تعزيز الوظيفة الدستورية للمهنة داخل منظومة العدالة.
فالتشريع، في هذا المجال الحساس، لا يُعد غاية في ذاته، وإنما وسيلة لضمان استقلال الدفاع، وترسيخ الثقة في العدالة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.ومن هذا المنطلق، فإن مشروع القانون رقم 66.23، كما تم تقديمه، يثير مخاوف مشروعة من حيث اتجاهه العام، إذ يوحي – في بنيته ومضامينه – بنزوع واضح نحو إعلاء منطق التنظيم الإداري والضبط المؤسسي، على حساب منطق الاستقلال والوظيفة الحقوقية.
فبدل أن يُكرّس المشروع المحاماة كشريك دستوري في تحقيق العدالة، يبدو أنه يعيد تموضعها في موقع الفاعل الخاضع لمنطق الإدارة، بما يحمله ذلك من مخاطر على توازن الخصومة القضائية وعلى قدرة الدفاع على أداء دوره النقدي والحمائي.
وتزداد هذه المخاوف حدة إذا ما لوحظ أن أغلب المقتضيات المثيرة للجدل في المشروع لا تنبع من ضرورة عملية ملحّة أثبتتها الممارسة، بقدر ما تعكس تصورًا معياريًا لدور المحامي، يقوم على تقليص هامش الاستقلال الذاتي، وإعادة ضبط المهنة وفق منطق الانضباط المؤسساتي.
وهو تصور يتعارض مع فلسفة دولة الحق والقانون، التي تجعل من استقلال مهن العدالة ضمانة أساسية للمجتمع بأسره، لا امتيازًا ممنوحًا لفئة مهنية بعينها.وعليه، فإن النقاش العمومي والمؤسساتي حول مشروع القانون رقم 66.23 لا ينبغي أن ينحصر في تفصيلات تقنية أو في مقارنة شكلية بين النصوص، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى مساءلة الخيارات الكبرى التي يؤسس لها المشروع، وإلى طرح السؤال الجوهري الذي يختزل جوهر هذا النقاش:
أي محاماة نريد في مغرب دولة الحق والقانون؟هل نريد محاماة مستقلة، ناقدة، قادرة على الدفاع عن الحقوق والحريات، ومؤهلة للقيام بدورها التاريخي كسلطة مهنية موازية داخل منظومة العدالة؟ أم نريد محاماة منضبطة، مُدارة، تُختزل وظيفتها في تنفيذ مهام تقنية، وتُفرغ تدريجيًا من بعدها الحقوقي والنضالي؟.
إن الجواب عن هذا السؤال لا يهم المحامين وحدهم، بل يهم المجتمع ككل، لأن مستقبل العدالة، في جوهره، رهين بطبيعة الدفاع الذي يُراد تكريسه: دفاع حر ومستقل يشكل ضمانة للديمقراطية، أم دفاع مُقيّد يتحول إلى حلقة ضعيفة في منظومة يفترض فيها التوازن والتكامل.
ومن ثمّ، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في سن قانون جديد، بل في اختيار النموذج المجتمعي للعدالة الذي نرغب في ترسيخه للأجيال القادمة.





