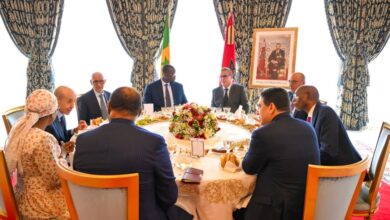نَادِي الْمُلُوك

قصة ساخرة من عمق المجتمع.. اقرأها وشاركها في الحال مع أصحابك العزّاب..

يقول الراوي: “تزوجت. مرحباً بك في نادي الواجب المقدس. استلم مفتاح الزنزانة، ولا تنسَ توقيع عقد السجن المؤبد؛ لا زيارات، لا عفو، ولا مهرب. في السنة الأولى، بدت الأمور محتملة؛ كانت الشعلة لا تزال ملتهبة، لكنها لا تحرق سوى أطراف الأصابع. بدا كل شيء قابلاً للحياة؛ قبلة قبل النوم، وعبارات رومانسية مثل “تصبح على خير يا روحي”، وما شابه من الكلمات المعسولة. وبعد ثلاث سنوات، أصبحت زوجتي تشبه أختي التي لم تكمل تعليمها والتي مكثت بالبادية في احضان الطبيعة. الاثنتان لهما نفس أسلوب تقليب القنوات، والردود المتعبة ذاتها على أي سؤال، ونفس النظرة المقتولة كذلك. يا إلهي، حتى نوع الشامبو ذاته.
وبعد خمس سنوات، تحوّلت زوجتي إلى نسخة من والدتها؛ الأواني تطقطق ليل نهار في المطبخ، ونظراتها الثاقبة تفحصني من الرأس إلى القدم كما لو كنت مراهقاً ضُبط وهو يعبث بهاتفه في الثالثة فجراً، إضافة بالطبع لحركات الغضب الصامت بسبب ودون سبب، ولازمة “لا شيء. أنا بخير..” والتي تعني، في الحقيقة، أن هناك حرباً ضارية تدور في داخلها، لكنها لا ترى جدوى في شرحها لي. أما الأطفال؟ آه منهم! صراخ متواصل، حفاظات متسخة، بلل على القميص الذي ارتديته للتو، وركض مذعور إلى قسم الطوارئ في الثالثة فجراً وحرارة الطفل تقترب من لهيب أفران البيتزا. تخيّل أن هذا هو الزواج. لا ورود حمراء، ولا عشاء على ضوء خافت، بل شموع كعكة سقطت وأنت تحاول إطفاءها بينما يمسك بها ابنك بيديه.
تخلَّ إذًا عن تعاريفك الكلاسيكية للارتباط…
الزواج، أعزك الله، أن تكون رجلاً صلباً، لا تدمع عيناه أمام فاتورة الكهرباء، أن تعرف كيف تربط حفاظة رضيعك وهو نصف نائم، وأن تمسك في اليد الأخرى طفلاً يحاول القفز من الأريكة متحدياً قوانين الجاذبية. والمرأة؟ ينبغي أن تكون أماً رؤوماً، مليئة بالتضحيات، عيناها محمرتان من قلة النوم، ومع ذلك تصطنع ضحكة راضية من شدة الإرهاق؛ فالتعب يشوّه ملامح الوجه حتى يظن المرء أنه يبتسم. خدعتنا الإعلانات يا حبيبي؛ صور الأزواج المثاليين الممسكين بأيدي بعضهم البعض في المراكز التجارية، والسفر كل نهاية أسبوع إلى أمكنة بسحر المالديف وصخب لوس أنجلِس وشاعرية البندقية…
أكاذيب…
لم يخبرنا أحد عن الجوارب غير المتطابقة بعد بحثك عنها في الدولاب، أو الدموع المكتومة، أو الملاعق التي تختفي وتُكتشف لاحقاً في حقيبة المدرسة. ومع ذلك، تستمر الحياة. لماذا؟ لا أدري؛ ربما لأن ذلك هو القضاء والقدر، أو لأن قلبي – رغم كل شيء – يحب هذه الفوضى الصغيرة.
وذات يوم، فتحت الباب فوجدت على طاولة المطبخ رسالة بخط يدها، قصيرة ومباشرة: “سافرت، لا تسألني متى أعود، الأولاد مع والدتي وستسلّمك إياهم هذا المساء”. تركت كل شيء؛ البيت، الصراخ، السجن. هل هربت؟ لا. لقد فازت برحلة مفاجئة إلى باريس مع صديقاتها عبر مسابقة على تطبيق إنستغرام. ثلاثة أيام، أرسلت لي خلالها صوراً وهي تضحك تحت برج إيفل، أما أنا؟ فكنت في المنزل، أبدّل الحفاظات، و أعدّ رضعات الحليب، وأواجه جحيم أغنية “بيبي شارك” على موقع يوتيوب. في تلك الليلة، جلست على الأريكة، وقد بللني أحد الأطفال، بينما رمى الآخر لعبته داخل المروحة.
وضحكت من أعماق قلبي. لأول مرة.. شعرت أنني متزوج فعلاً؛ لا لأني أعيش الجحيم ولكن لأني لا أفرُّ منه…”