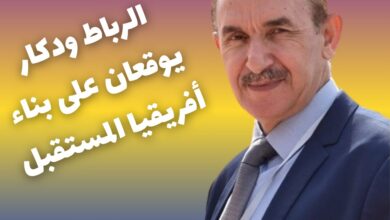باريس_أحمد الميداوي
منذ خمسين عاماً ونحن نعيش على ثقافة العدم…عدم الحرية، وعدم المساواة، وعدم العدالة الاجتماعية، وعدم المحاسبة على أكثر من صعيد… وهي ثقافة تأسست وما تزال على منظومة من الأفكار والمصادرات والرؤى التي تقصي المتغيرات في بنيتنا الاجتماعية والسياسية، وتكرس الخواء والعجز الذي بات من سمات ما يمكن تسميته بأزمة وعي الأزمة.
وبكلمة أخرى، فإن المشهد السياسي المغربي بشقيه الحزبي والنقابي، ظل طوال عقود قابعا في متاهات الشعارات والخطابة الفارغة، عاجزا عن تجديد نفسه وآليات تفكيره بما يمكنه من تكسير ثقافة الأنا المتضخمة بمفهومها السلبي، ومعها أزمة الوعي بالأزمات التي يتخبط فيها البلد والتي تتطلب التوقف عند نقطة في غاية من الأهمية لكونها تجلياً وتمظهرا لأزمة الوعي السائدة في الأوساط الحزبية والنخب الحاكمة.
ويتعلق الأمر بالصورة التي تُكونها الأحزاب التي تقول عن نفسها وطنية أو تقدمية، عن ممارسة الحريات العامة ومنها حرية التعبير. فهي من حيث الخطابة تبدو على وعي كبير بالأزمة وبحق المواطن في الإعلام، لكنها تتفوق من حيث التطبيق على المدارس السلطوية، في تضييق الخناق على كل من سار في الاتجاه المعاكس.
وللصحافة المغربية تجربة ماضية مريرة، مع حرية القلم والتعسفات التي تصاحبها، والتي كادت تنمحي، لحسن الحظ من مشهدنا الإعلامي والسياسي.
ويحيلنا هذا الوعي “الشقي” إلى أزمة الوعي بالكثير من المشاكل التي غالبا ما تعالج، إما من خلال إدراك ضيق لعمقها، وهو ما يزيدها استفحالا، أو من خلال نسخ مرتجل للنماذج الأجنبية، كما هو الشأن في قطاعات عديدة ومنها التعليم، الذي يسطو كل مرة على نمط بيداغوجي أجنبي، في محاولة لتطبيقه حتى وإن اختلفت المسالك التربوية والمناهج التعليمية، فنُصاب بالخيبة حينما ندرك بأن مدرستنا وجامعتنا ابتعدتا كثيرا عن واقع نشأتنا وبيئتنا المغربيتين.
وبابتعادهما عن محيطهما الاجتماعي والاقتصادي، لن تزيدا سوى في إنتاج العاطلين واستفحال البطالة التي ليست كما يعتقد القائمين على الشأن التعليمي، والقابعين في أزمة الوعي الشقي، مشكلة اقتصادية صرفه، بل هي مشكلة نفسية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية في آن واحد.آفة تعليمنا أيضا أنه يكرس الهوة بين النجباء والضعاف من التلاميذ، حيث الصنف الأول وينتمي إلى الفئات الميسورة، متفوق بشكل كبير تحصيلا ومعرفة على الصنف الثاني من أبناء الأحياء الفقيرة.
ولذلك، فإن المقولة المأثورة “لولا أبناء الفقراء لضاع العلم”، أصبحت معكوسة فعلا وواقعا بمغربنا الجميل، بحكم المناهج الدراسية الجديدة القائمة على مقررات طويلة تجبر من جهة، المدرّسين على اختصار حصص الشرح والتلقين، وتُحتّم على التلاميذ من جهة أخرى، اللجوء إلى دروس الدعم لاستكمال التحصيل والفهم بمعدل 300 درهم للساعة، بالنسبة للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء.. و200 درهم للمواد الأدبية.
وبما انه وعي ممزق ومنقسم على نفسه، فانه ينحل إلى تناقضات لا متناهية تعيد إنتاج الرؤية السياسية الأحادية المؤدية إلى تغييب الفرد واعتباره صفرا مهملا في إطار تعميم ثقافة اجتماعية تقوم على رفض الآخر، ونفيه بالمعنى الاجتماعي والسياسي.
وبهذا المعنى فإن أزمة الوعي عند النخبة الحاكمة، ليست تعبيرا عن مجتمع عاجز عن إعادة إنتاج نفسه معرفيا، بقدر ما هو تعبير عن أزمة حقيقية في بنيتنا السياسية وما تتضمنه من مشاريع نظرية يقوم بتوظيفها قادة التنظيمات السياسيةً بما يتناسب ومصالحهم الشخصية والسياسية.
ومن هنا فإن أحد أهم السبل لمعالجة أزمة الوعي السائدة في أوساط نخبنا السياسية، تكمن في تعميق الوعي بالذات، وإدراك مواطن الضعف وتحليلها على أساس الرؤية النقدية المنفتحة، وتقوية المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار، وتكريس مبدأ المحاسبة والرقابة، وإلا سنرتد إلى أحط لحظاتنا التاريخية.فمجتمعنا يعاني على المستوى السياسي عموما من مجموعة من الإشكاليات يمكن اختصارها، من جهة، في توظيف أشكال إيديولوجية، لا تتوافق مع المرحلة الراهنة ومقتضيات التطور العالمي، ومن جهة أخرى، في غياب الديمقراطية من جراء ممارسة التهميش المنظم على المواطن، وتزايد ظاهرة الولاءات الشخصية والمحسوبية والتمييز القائم على أسس مناطقية أو جهوية، وأيضا وهذه أم المعضلات، اعتماد الشعارات والخطابة الفارغة التي أصبحت واحدة من عاداتنا ومن عادات العرب بشكل عام، وبها يصنفنا الغرب، ب”الظاهرة الصوتية”.فكلمة “كلب” لا تنبح، ولا تعض، لكنها تحيل على واقع عياني، إلى كائن معين، ينبح، ويعض، وتحيل على الاختلاف.
فهي صورة الكلب وشكله في ذهن من يعرفه، بل في نفسية من يعرفه، بغض النظر عن الشعور أو العاطفة والانفعال والاستجابة، التي ترافق عملية المعرفة ولا تنفصل عنها.
وهي لا تحتاج إلى خطابة لنفهم مدلولها. وكلمة عطر لا رائحة لها، ولكنها تحيل على ما لا حصر له من الروائح العطرة، وكلمة عِلم ليست عالمة، وكلمة شرّ ليست شرِيرة… ولكنها جميعها كلمات ومفاهيم، هي أسماء وأدوات معرفة العالم وتعقله، وإنشاء صورته في الذهن مع التجاوب مع المستجدات التي قد تطرأ عليه. ثم إن الأشكال والأساليب المتبعة من لدن نخبنا السياسية تعبر عن ممارسات ثقافية وسياسية لا تتجاوب مع المتغيرات الراهنة وتحدياتها المستقبلية، معبرة بذلك عن الخواء والعجز الذي بات من سمات ثقافتنا الراهنة المتسمة بالانكفاء على الذات والتخلف عن مواكبة التطورات الحضارية والتقنية المتسارعة.